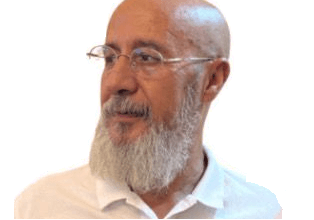هل من ضرورة لقيام كتلة ديموقراطية جديدة؟؟
كان الإعلان عن تأسيس الكتلة الديموقراطية بالمغرب العام 92 من لدن القوى الديموقراطية بالبلاد، فِعْلا مُفترضا، وواقعة عيانية أيضا في ظل وضع افترضها قسرا، مُثخن بالجراح والتّصدع.
وذلك من حيث:
أ – سيادة قوانين شبه استثنائية به-إذا جاز القول أطرت العباد والبلاد، دون أن تنفلت عناصره (=الوضع)، في ديناميته الخاصة والدائمة، باتجاه أي منحى مفتوح ومنفتح على صياغة للوضع ديموقراطيا. وهذا بما استتبعه من تتويج صارخ يُراد من مؤداه، ترسيم “عقلانية ” و”راشدة” لديموقراطية “محلية ” يُمنع ويحرّم إطلاقا تجاوزها.
ب – ثم من حيث أن هذا الوضع عيْنُه، كان يُراد له، هذه الوجهة وهذا المسار، في الشّق الاجتماعي منه بالخصوص، الذي شهد أكثر من أي وقت مضى، آنئذ، ترسيخا لا حدود له، لقيم المجتمع الاستهلاكي، الذي تتطلب عاداته وسياقات ممارستها (كما هو الحاصل الآن) أكبر مما تنتجه البلاد من احتياجاتها…وحيث أيضا بالمقابل – وكان هذا مدهشا- يترافق مع معدلات متزايدة الارتفاع لتكاليف المعيشة، ومعدلات مرتفعة للتضخم، مع معدلات إفقار قياسية في الحضرية والريف.
وإذن، وفي ظل وضع حالي لا يختلف عن الوضع السابق والمذكور إلا في الشكل، هل سؤال قيام كتلة ديموقراطية جديدة، أصبح قائما؟؟..حتى يكون في الوسْع وبالتّفاؤل المُفترض، طي مرحلة مأزومة من التاريخ المغربي والإقبال على أخرى مفتوحة؟؟
يجد سؤالنا، في طرحه مشروعية، مما قد يثيره بجانب ما ذكرناه سابقا، لقراءات متعددة لتاريخ المسألة الديموقراطية بالبلاد بخاصة، وللوضع السياسي هو الآخر بعامة، بما شهدته وتشهده صيرورته العامة، من استقامات ومنعرجات، إنجازات وإخفاقات أو بكلمة عامة: لما تكثّف في حصيلته التاريخية من عناصر مادية للتقدم أو للتخلف.
وبشكل أدق يمكن التصريح، بأن ما نبتغي قوله، هو أن تأريخا لتاريخ المسألة الديموقراطية بالبلاد، على أهمية تعقيده وصعوبة مهمته، وحتى يكون موضوعيا
واعيا، وفي مستوى اللحظة النقدية المرغوب ممارستها الآن لا يمكن أن تخرج عن نطاقين نراهما كالتالي:
نطاق أول: يعتبر أن المرحلة السياسية الممتدة من 2002 حتى حدود 2012 ، شهدت من التّمزق و من التناقض الحاد بين مكوناتها السياسية، الرسمية المنظمة! وغير الرسمية، في غياب أدنى وضوح برنامجي للأخيرة. ما أثقل الواقع بعبء لم يكن في متناول قدرته على التّحمل، وأضفى على الطموحات الديموقراطية نوعا من الضبابية لم تعد معها هذه الأخيرة قادرة على تلمس سياقات أو خيارات تحقّقها، إلا فيما لا يخرج عن دائرة ممارسة “الانحياز” والسياسوية بحسابات الربح والخسارة.
على أن هذه المرحلة من وجهة أخرى، وبما شهدته بالمقابل من تجارب محسوبة على الديموقراطية، وما تلى ذلك من مواقف وأحداث لم تكن تخرج بحال من الأحوال عن دائرة معادلة انغلاق/انفتاح، إن لجهة النضال الديموقراطي أو لجهة ضده. واستحقت بهذا وذاك ، اعتبارها صفحة استثنائية (بجانب الاستثناءات المعروفة) في تاريخ المغرب. يمكن أيضا وبموضوعية اعتبارها جزءا من التراث السياسي الوطني، يقتضي التعامل معه بروح نقدية واعية ومستمرة، بدليل أن بعض حلقاته لا زالت تجري إلى حدود اليوم. وإن بأشكال مختلفة. وأن بعض عناصره لازالت أيضا قادرة على الفعل- نحو ما- في صياغة المشهد السياسي.
نطاق ثاني: ويعتبر أن المرحلة التي شهدت ولازالت ذروة تجسيد الحلقات المذكورة، لهي الفترة الممتدة من 2012 إلى الآن.
إن هذه المرحلة بقدر ما شهدت بعض المغايرة والتّفرد في معطياتها لجهة انفتاح سياسي “مُلبْرل” بقدر ما عمقت بالمقابل(في ظل حكومة كارثية) الفوارق الاجتماعية ورسخت كل قيم المجتمع الريعي الاستهلاكي، بل ورسّمت سياسة القهر الاجتماعي..
وإن المفارقة الأكثر غرابة وإدهاشا في هذا، أن العناصر المادية والمعنوية التي تم تكثيفها في خدمة الإنفتاح المذكور هي نفسها التي تم تكثيفها في إعطاء مسحة تبريرية للقهر الإجتماعي المسلط على رقاب أغلب فئات وطبقات المجتمع.
على أن المرحلة هذه، نفسها، وإن عمّ لدى الشعب الإحساس بأعلى درجات النفور من “السياسة” الذي مافتئ هو نفسه أن تحول إلى إلى ما يشبه أزمة ثقة في كل ما يتصل بعملية التغيير المنشودة، فإنها شهدت ولاتزال، وبالمقابل تصاعدا في الوعي النقدي والحقوقي الشعبى، يجسد أكثر من أي وقت مضى أحقية وصدقية العمل التنظيمي السياسي الدؤوب، في قاعدة الفئات العاملة وعموم أفراد الشعب.
وعليه، فإن هذا الوعي الشعبي/النقدي المتكون والمحصل كمعطى، للطفرة المذكورة، والذي من المُفترض منذ الآن، أن يقف ضدا على كل هجمة شرسة يمكن أن تستهدف وعي الإنسان المغربي، مشاعره ومصيره، هو نفسه رهان المنعطف الذي يشهده المشهد السياسي الراهن، في أن تتحقق الديموقراطية المتوخاة أو تنعدم.