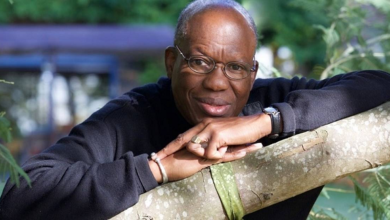ذاكرة حسن المنيعي لا تنسى

الكتابة نقد وتفكيك وتجربة موضوعية، إنها حكم جمالي وفني وفكري، وقبضة بغية الالتحاق بالأصل الغائب وتفكير في عالم المعاني من خلال الذات المبدعة، إنها الواسطة بين اللغة والذات الناقدة فحضور حسن المنيعي في المسرح والتربية أبدع لنا عدة مراجعات نقدية فظهوره كأستاذ مربي وكناقد مترجم يوضح لنا هيئة الدلالة ومقاصدها والرغبة في التشكيل في قراءة هذا المبدع المنشي من طرف الإعلاميين ومؤسسي مسرح الجامعي. فاختياري لهذا الموضوع هو رد الاعتبار لأستاذي ولفكره ولبراعة عبقريته، لأنه دوما يحثنا عن البحث والقراءة في المهمش، وهذا التفكيك هو مساءلة للدعم المسرح الجامعي الذي ذكر تريا جبران وعبد الجبار السحيمي دون ذكر مؤسس المسرح الجامعي شأنه شأن أساتذة كعبد الرحمان بنزيدان ومحمد السرغيني وإبراهيم الهنائي ومحمد الكغاط وعز الدين بونيت والغزيوي بوعلي ونوال بن براهيم وغيرهم. إن هذا التشكل فعل القرائي لديه هو تشكل يساعدنا على استنطاق النظام الدرامي في المغرب قصد إيجاد مواقع المعنى الشخصي في كل فضاءاته. فالتفكيك لا يتوجد في كليته ولا يدجن ولا يختزن، بل هو تواصل وقول ما لا يستطيع المصنوع قوله، لأن تفكيك المنظومة لا يعني اختزالها إلى أدوات منهجية القابلة للهجرة نحو النصوص العميقة، والمعارف الجيدة هي التي تمنح نفسها للناقد قصد تحديد مفهوم التفكيك، فحسن المنيعي يدعونا دوما إلى الفهم والنقد لمعرفة الكتابة الركحية والقراءة البصرية الممسرح، حيث يتراءى لنا الناقد مع العرض المسرحن ويتواصل معه ليحقق هذا العزم الإبداعي الغير القابل للاختزان، فحسن المنيعي في متونه النقدية والإبداعية يعكس الشعور الحيوي الموسوم بالبحث والوعي المنهجي. فهو يمارس التفكيك ليسمح له إلى عدم اختزال تجارب في بعدها الرومانسي، بل في بعدها التجريبي والتاريخي المتعدد، لأن المنيعي يحاول دوما أن يؤسس للنقد وللترجمة مكانا داخل العلوم الإنسانية التي هي موطن الأسئلة والتجريب والإبداع، فمتونه هي الوسيلة والغاية من وراء إثبات مرجعيات عالمية، لأنها تمثل جانب الإيحائي المرجعي والمنطوق المدون كملازم للغرض المسرحي، فهي خطوة جوهرية يتواصل مع الذوات المتشظية والصامتة والتي فكرت وتفكر في هذا الناقد وتتكلم مع نفسها. فهو المرجع والمرجعية ينطق به الشرق وخاصة مصر، لأنه يحمل دلالات مغايرة وذلك تحت وصاية الخلق والإبداع، لأن رسم ملامح الاختلاف عند هذا الناقد لا يعني الوصاية على الإبداع، بل يشير إلى مسارات النقد العالمي. فتحرير الإبداع ليس عودة إلى التأريخ ولا الوصف، بل الكشف عن البدائل الممكنة عن طريق المقولات اليونانية والفرنسية والعربية التي تفرض المطابقة بين الفكر والواقع في كتبه.
إن الناقد حسن المنيعي يرسم لنا دوما بعدين أساسيين في نقده للجسد أو للنص المسرحي أو للرواية أو الشعر، بعد سيكولوجي وبعد اجتماع حيث يتجلى ويتمظهر في بناء البنية التحتية، بما تحمل من تناقضات وأبعاد إديولوجيا، وبعد آخر سيكولوجي يرافق تعارضات بين الجسد والقناع الشخصي الذي يرافق التعارضات المفاهيمية في شكل حركات التفاوت الإبداعي النقدي الغير القابل للاختزال، وهذا الاستنباط المعرفي والاجتماعي والنفسي والفكري يؤسس لنا شعرية نقدية التي تتجاوز أصول التطور والنشأة، لكي تدمجنا في ولادة جديدة للكتابة النقدية، ولتصبح شهادة التأثير في الوجود الإنساني ولتزحزح الكيان اليقيني العربي والرأسمال البشري. إذن أصبح حسن المنيعي في المنابر الإعلامية غير مرغوب فيه باستثناء أحد المهتمين بالمسرح الذي أشار إليه إشارة خاطفة وهو (بوسلهام الضعيف) أما الجرائد الورقية فلم تعر اهتمام لهذا الطود العظيم الذي أسس المسرح الجامعي، وكذا تأسيس المناهج النقدية في فضاء الجامعات. إذن ينبغي أن نأخذ بأن المفكر يبقى مفكرا مهما طال الزمن أو قصر وأنه لم يأتي لتفسير هذا العالم بل لتغييره إلى ما هو أحسن.
وخلاصة القول، ينبغي علينا أن نعيد لهذا المبدع والناقد والمترجم براعته الفكرية لكي يعرفه القارئ العادي والمثقف والصحفي والفنان، لا أن ننتظر عمرا طويلا لنسير حفاة عراة.
فحسن المنيعي يظل دوما يدافع عن الحرية المجتمعية، والإنسانية،فهو الذي يؤكد على أن الإنسان مهما قوي شأنه يظل دوما باحثا عن الحرية، وخاضعا لقوانينها وأقوالها، فهو الذي يتحمل المسؤولية أمام هذا المجتمع.
فالمبدع دوما أن وجوده يسبق ماهيته كما يقول سارتر فهو مشروع مستقبلي يتوجد أولا في هذا الكون، ثم يبدع قارته المعرفية ككينونة وماهية بكل حرية، وهذا الشرط الإبداعي لا ينبغي أن يلغي الضرورة أو الحتمية الاجتماعية. ولا البيئية ولا النفسية، ولا البيولوجية ومما يكن فإن حسن المنيعي في أطاريحه النقدية سيظل دوما مرجعا أساسيا لكل الباحثين والدارسين، فهو المفكر الذي يدعو إلى تأسيس ابستمولوجيا نقدية تراعي مسألة التطور المعرفي والسياقي اللذين ساهما في استقلالية النقد من حيث الموضوع والمنهج.